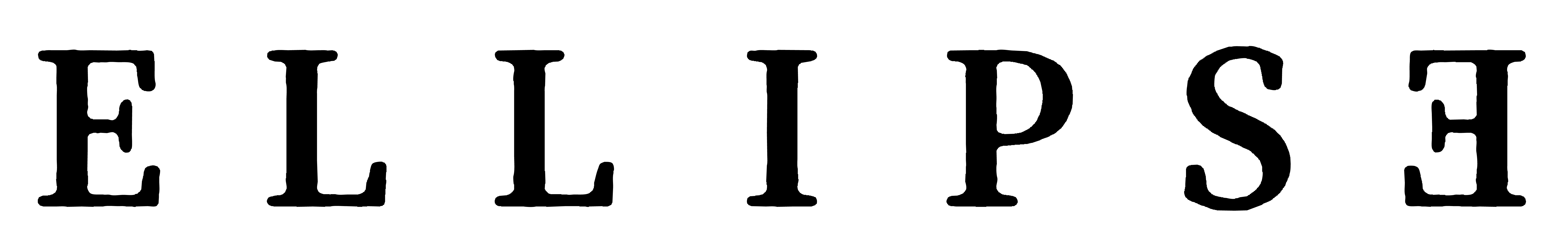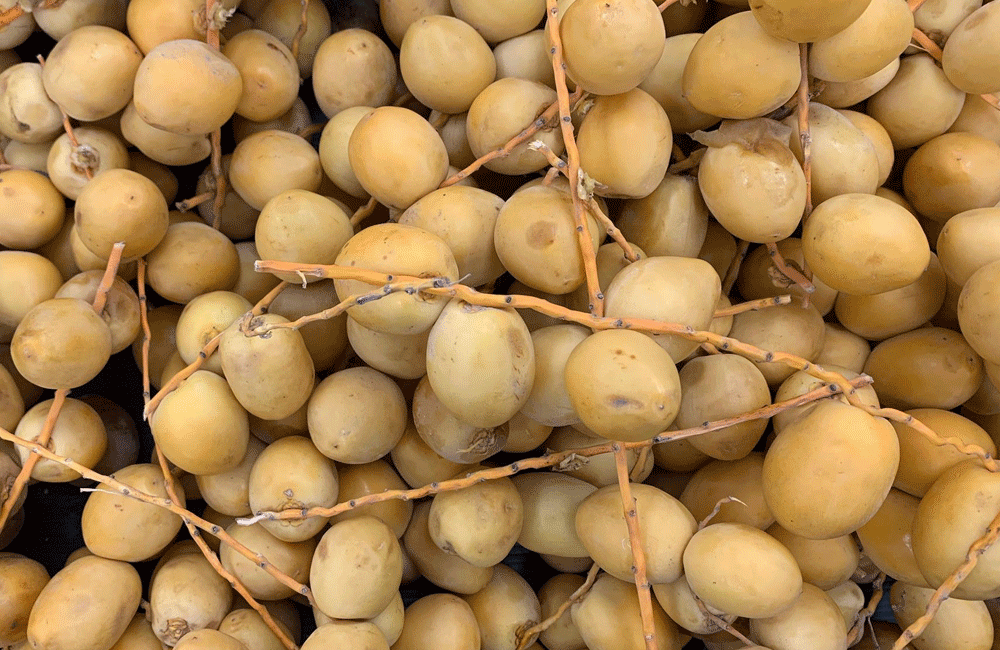Louisa: The Funeral Wake
second chapter of the novel Cactus Girls (Banat al-sabbar بنات الصبار) by Karima Ahdad
Katherine Van de Vate
Louisa: The Funeral Wake
Many people find occasions such as funerals a chance to celebrate. Some women even look forward to them as an opportunity to justify their existence. After they finish the usual lamentations for the deceased, they storm the kitchen to help cook and serve special dishes to the mourners—milk and dates on the first day, couscous with chicken on the second, and stewed lamb with plums on the third.
Su’dia, my late husband’s older sister, didn’t leave the kitchen once during the three-day mourning period. She dished half of the cooked meat onto the serving platters before putting the other half, along with its gravy, into a plastic container which she tucked between her thighs. She poured dregs of milk into plastic bottles and crammed dates into bags. She had even brought take-away boxes to fill with couscous. As for the sweets, she stuffed them into her enormous bra, cramming its cups with food as if famine were knocking at the door.
During those three days, Su’dia must have gained ten kilos. She had come not to grieve, but to gorge. Weddings, funerals, and feasts of sacrifice to mark the birth of a child—they were all the same to her, a chance to eat. Su’dia had subsisted her entire life on leftovers from these occasions. Every birth, death, or wedding was a reason to celebrate, a chance to fill her stomach for two straight weeks without paying for a thing. Today, as she forced meat into bags, her face revealed no grief for her dead brother. She had wept and wailed with the other women, as expected, but always with a sharp eye on the clock, since a life of hunger still awaited her and she had to make the most of this opportunity.
On the third day of the wake, I sat in my bedroom beside my daughter Sonya. She was still inconsolable, her face almost purple from all her crying. Hugging her gently, I promised her that time would heal her grief and help to banish its memory. Snuffling loudly, Sonya said: “I don’t understand! How can anybody think about food during a funeral?”
I thought of Su’dia’s bulging stomach and giggled despite our tears.
Wiping her eyes, Sonya asked: “Have you seen Auntie Su’dia? She’s eaten so much she’s about to throw up. Can’t she at least pretend to be sad about her brother’s death?”
I looked at her distractedly. “The only time Su’dia gets enough to eat is celebrations and family gatherings such as these.”
Sonya’s lower lip trembled. “Poverty is horrible,” she said quietly.
“I’m poor too,” I retorted. “I’ve been poor my whole life. But I wouldn’t act like that, not for a second. Poverty is no excuse to behave like an animal.”
Leaving the room, I closed the door behind me as Sonya collapsed onto the bed. She’d been awake for three days weeping and staring into the dark with hollow eyes, as the tears ran down her cheeks. Even her little sisters hadn’t grieved so much. But I knew Sonya wasn’t crying just for her father. It was our ominous future that she feared.
I went back to the sitting room reserved for women mourners. All the women of the family were present, together with our former and current neighbours and their friends. Some of the women I didn’t recognize, but others looked familiar, although I couldn’t quite place them. Every type of woman under the sun was there. They ranged from skinny ones concerned not with food, but with giving us comfort and support during this trying time, to fat ones who ate without stopping and filled their pockets with sweets. Women I’d never set eyes on had brought all their children, from the eldest to the youngest, to join in the feasting, forcing food down their throats until they retched.
Vomit, foul smells, cooking odours, fruit and sweets of every kind, almonds, peanuts, mixed nuts, coffee, tea, sugar. The hypnotic drone of the Qur’an over it all. Crowding, fat bodies jostling, huge stomachs and breasts, embroidered dresses, screaming children, the voices of men in the adjoining room, flies, the reek of sweat and bad breath. In the midst of it all sat Yamina, my husband’s younger sister, prattling on and on about the virtues of her late brother. Yamina was a kindly woman who liked everyone and mourned at every funeral. She wept constantly, even for people she’d never met. She was so sensitive and delicate, it seemed her entire body could dissolve into a waterfall of tears. Whenever she paused for breath, she beat her chest with a plump, freckled hand and exclaimed in a voice hoarse from sobbing: “Ah, Hamid, my beloved brother, you’ve broken my heart like no one before!”
Throughout the three days of the wake, Yamina must have repeated this lament hundreds of times. While there’s nothing wrong with grieving a departed brother, it’s shameful that we remember a person’s merits only after he’s gone to his grave. Yamina wasn’t a bad sort, but the current carried her wherever it went. She could move in a heartbeat from loving everyone to hating them. When she joined a group of women who were bad-mouthing someone, she’d do the same, even if the person under attack had been kind to her. Perhaps she feared they’d exclude her if she didn’t join in their spiteful talk.
As Yamina wailed and Su’dia ate, I sat lost in thought, trying to recall Hamid’s features. I rubbed my swollen eyes, but his face had descended from my memory into the grave, along with the rest of him.
Hamid, the love of my life. First he was my husband, then he was the father of my daughters. Now I’m his widow. I recalled how only three days ago, he had stretched out on the couch, propping his calloused feet on a cushion. He asked me to bring him a glass of water and downed it in three gulps, thanking God: “al-Hamdu lillah!” He rose for his meal—an egg fried in olive oil and bread fresh from the oven, followed by a glass of mint tea. As usual, he didn’t thank me. He sat back down and tuned the TV to a religious programme hosted by a Shaikh. As I washed the dishes, I could hear the preacher haranguing his listeners to submit to God’s will and ranting against dialysis. Claiming illness was a divine test, he thundered: “Only God knows its reasons, and it’s against God’s will to treat our diseases with medicine!”
I came out of the kitchen to clear away the dishes. As I wiped my hands on my apron, I asked Hamid how work was going. He grumbled: “This week we didn’t catch a thing; in fact, we’re out of pocket because we had to buy fuel for the boat.” He stroked his long beard, grey before its time. “That’s normal for fishermen; we’re used to it. Life’s a gamble—you may win a little or you may lose everything. But when we fishermen gamble, we always lose.”
I sighed as a mountain of despair pressed down on me. How I longed to bring a glimmer of hope into our gloomy lives. For those of us used to despair, searching for hope is like a daily workout. “Surely God will bring us relief someday,” I said, “surely He will….”
I returned to the kitchen to prepare food for the following day. After two hours of peeling vegetables and scrubbing pots and pans, I finally emerged to find Hamid sacked out on the couch. He often collapsed from exhaustion at this hour, but this time he wasn’t snoring and he didn’t rise for dawn prayer. I shook him roughly to wake him for breakfast, but it was useless. He’d slept his final sleep and nothing would ever wake him again—no person, job or responsibility, no alarm or phone ring, no prayer or whistle of the pressure cooker. Hamid was gone. My husband was dead.
حفل الجنازة
اليوم يوم حفلةٍ بالنسبة للكثيرين، وهناك نساءٌ كنّ ينتظرن بفارغ الصّبر حدوث شيء كهذا كي يثبتن وجودهن في هذا العالم. بعد انتهاء حصّة النواح والعويل، تنتقل هؤلاء النّسوة إلى المطبخ. يُساعدن في الطبخ، ويُقدّمن الطعام للمعزّين: التمر والحليب في اليوم الأول، والكسكس بالدجاج في اليوم الثاني، واللحم بالبرقوق في اليوم الثالث.
سُعدية، أخت زوجي الكبرى، لم تخرج من المطبخ أبداً طيلة هذه الأيام الثلاثة. تضع نصف اللحم المطبوخ في أطباق التقديم، وتدسّ النصف الآخر بمرقه في كيس بلاستيكي مخبّأ بين فخذيها. تملأ القناني البلاستيكية بالحليب الذي تبقّى من كؤوس المعزين، وتعبئ أكياساً أخرى بالتمر، كما أحضرت معها علباً بلاستيكية لملئها بالكسكس، أما الحلويات فمكانُها هو حمّالات الصّدر الضخمة التي ترتديها. كانت تدسّ الطعام في الأكياس وكأنّ مجاعةً قادمة بلا شكّ.
ازداد وزن سعدية، خلال ثلاثة أيام، عشرة كيلوغرامات على الأقل. فهي لم تأتِ للعزاء، بل جاءت للأكل. لا فرق لدى سعدية بين حفلاتِ العقيقة والأعراس والجنازات، ما دام الطّعام يُقدم فيها كلّها على حدّ سواء. لقد عاشت حياتها كلّها من بقايا الحفلات. كلّ ولادة أو زواج أو موت، بالنسبة لها، حفلة، فرصة لملء البطن طيلة أسبوعين دون الحاجة إلى التسوّق. منظرُها وهي تأكل وتملأ الأكياس باللحم لا يشي أبداً بأنّها حزينة على أخيها الميّت. لقد بكت، هذا صحيح، لكنها انتبهت بسرعة إلى أن حياة الجوع ما زالت في انتظارها. عليها إذن أن تغتنم الفرصة.
في اليوم الثالث من الجنازة، كنت أجلس إلى جانب ابنتي صونيا في غرفة النّوم الخاصّة بي. كانت ما تزال غارقة في البكاء مثل اليوم الأول بالذات. بكت حتى احترق وجهها وأنفها. ضممتُها إلى صدري بحنان، وأخبرتُها أن الوقت وحده كفيلٌ برمي هذا الحزن في غياهب النسيان ومسح الأموات من ذاكرتنا. شهقت بحرارة حتى تدلى خيط مخاط من أنفها المحمرّ، وقالت:
ـ لا أفهم كيف يستطيع الناس التفكير في الأكل خلال جنازة…
وسط الدموع انتشلت صونيا ضحكة محتشمة مني وقد ذكرتني ببطن سعدية المترهّلة.
أضافت بسرعة وهي تمسح دمعتها:
ـ هل رأيت عمّتي؟ لقد أكلت حتى تقيأت.. ألا يعرف هؤلاء الناس كيف يتظاهرون قليلا بالحزن على ذويهم؟
أجبتها وعيناي شاردتان في الفراغ:
ـ الحفلات والتجمّعات العائلية هي فرصتها الوحيدة لتشبع…
ارتجفت شفة صونيا السّفلى، وقالت في ما يشبه الهمس:
ـ الفقر كافر.
وبسُرعة أجبتُها:
ـ أنا أيضا فقيرة، وعشت حياتي كلّها في الفقر، لكنني لم أجرؤ يوما على القيام بمثل هذه الأفعال.. الفقر ليس مبرّراً لتتحول إلى وحش.
خرجتُ من الغرفة مغلقة الباب خلفي تاركةً صونيا مستلقية على السرير كجثة بلا قبر. لم يُغمض لها جفنٌ طيلة ثلاثة أيام. ظلّت مستيقظة تحدّق في الظلام كبومة والدموع تنهمر بلا هوادة على خدّيها. حتى أخواتها الصغريات لم ينخرطن في البكاء مثلها. كنتُ أعرف أن ابنتي الكبرى لم تبك فقط على والدها، بل بكت أيضا على مصيرنا المكشّر بعد وفاته.
عُدت إلى الصّالة التي تجلس فيها النسوة. نساء العائلة كلهنّ موجودات. الجارات أيضا وصديقات الجارات. الجارات القديمات، ونساء أخريات لا أعرفهنّ ولم أرهنّ يوما. بالإضافة إلى نساء بوجوه مألوفة لكنني لا أتذكر جيدا أين التقيتهنّ. نساءٌ من كل الأنواع.. النحيفات اللواتي لا يأكلن شيئا ولا يهمهنّ الأكل بقدر ما يهمهنّ تقديم العزاء والوقوف معنا في مصيبتنا. البدينات اللواتي لم يتوقفن عن الأكل طوال الوقت ودسّ الحلويات في جيوب جلابيبهن. نساءٌ لا أعرفهنّ أحضرن أولادهنّ كلهم ابتداء من الأكبر وحتى الأصغر، يأكلن ويُدخلن الطعام في أفواه أولادهنّ حتى يتقيؤوا.
قيء، روائح كريهة، روائح الطّعام وهو يُطهى، فواكه وحلويات من جميع الأنواع، لوز وجوز ومكسرات، قهوة وشاي وسكّر، قرآن يُتلى، لحمٌ وشحم، كروشٌ ضخمة، نهودٌ كبيرة، جلابيبُ مزركشة، ازدحام، أجسادٌ متلاصقة، صخبُ أطفال، أصواتُ رجال قادمة من الغرفة الأخرى. ذباب، روائح عرق وأنفاس مقززة… وسط كل هذا، كانت تجلس يامنة، وهي أخت زوجي الصغرى. لم تتوقف عن الكلام وتعداد مناقب أخيها. كانت امرأة طيبة وتحبّ الجميع، وتبكي في جميع الجنازات، تبكي حتى على الناس الذين لا تعرفهم، تبكي طول الوقت. حسّاسة وهشة حتى يخال الواحد أن جسدها كله سيذوب ويتحول إلى شلال دموع. حين تنتهي من الكلام، تشرع في الضّرب بكفها البدينة المنمّشة على صدرها، وهي تقول بصوت أجشّ تغالبه الدّموع:
ـ آه.. لقد أحرقت قلبي يا أخي يا حبيبي… أحرقته كما لم يحترق من قبل أبدا.
كرّرت هذه الجملة مئات المرات خلال ثلاثة أيام. ليس عيبا أن يبكي الإنسان لأن أخاه انزلق من حافة الحياة، العيب ألاّ نتذكر مناقبه وحسناته إلا بعد أن يسقط في حفرة الموت. يامنة لم تكن شرّيرة، إلا أن التيار كان يجرفها معه أينما ذهب، بحيث تستطيع أن تتحول من مُحبّة للجميع إلى كارهة لهم في لحظة واحدة. حينما تجلس في مجمع نسائي ويتحدّثن بالسّوء عن شخص ما، حتى لو كان هذا الشخص قد أعطاها قلبه وعينيه، ستتحدث عنه بالسّوء كذلك. وكأنما إذا لم تفعل ذلك، تخاف أن ينكرن وجودها معهنّ.
يامنة تولول، سُعدية تأكل. وأنا صامتة، شاردة الذّهن. مُسافرة إلى عالم آخر أحاول استعادة ملامح حميد. أحكّ عينيّ المتورمتين في محاولة لرسم تعابير وجهه من جديد، لكنها كانت قد سقطت من ذاكرتي بسرعة وهوَت معه إلى القبر.
حميد، الذي كان حبّ حياتي، وتحول إلى زوجي، ثم إلى أب بناتي، ثم أصبحتُ أرملته. قبل ثلاثة أيامٍ فقط، كان هنا. متكئا على الأريكة واضعاً قدميه المتحجّرتين فوق مخدّة. طلب مني أن أحضر له كأساً من الماء. شربه على ثلاث دفعات وحمد الله. نهض، تناول بيضة مقلية بزيت الزيتون في الفطور مع خبزٍ أخرجته للتوّ من الفرن، وشرب شاياً بالنعناع. كالعادة، لم يشكرني، إنّما اتكأ مجدّداً، وأشعل التلفاز، حيث وجد برنامجا دينيا يقدمه أحد الشيوخ. كنت أغسل الأواني في المطبخ، وكان الشيخ يتحدث عن الاستسلام لقضاء الله وقدره. يصرخ أنَ غسل الكليّ هو تحدّ لإرادة الله، وإرادة الله اقتضت بأن المرض ابتلاء من ورائه حكمة، ولا يجب أبدا أن نتحدى الله ونأخذ الأدوية للشفاء.
خرجتُ من المطبخ أمسح الطاولة التي تناول عليها فطوره. سألته عن العمل وأنا أمسح يدي في المئزرة. أجابني متذمّراً “لم نربح شيئا طيلة هذه الأيام.. بل خسرنا من جيوبنا لدفع ثمن وقود المركب”. داعب لحيته الطويلة الشائبة قبل الأوان، وأضاف دون أن ينظر إليّ “على كلّ حال، هذا شيء طبيعي ومعتاد في عملنا.. نحن نقامر على الحياة فقط، وفي المقامرة إما أن تربح قليلا وإما أن تخسر كلّ شيء، أما المقامرون مثلنا فهم أشخاص خاسرون دائما”.
تنهدتُ بعمق وقد سقط جبل من اليأس على قلبي، لكنني أردتُ أن أومض نقطة أمل في عتمة أعماقنا. عندما نعتاد اليأس يصبح الأمل رياضةً يومية. قُلت:
ـ لا بدّ وأن يفرّجها الله يوما.. لا بدّ.
عُدت إلى المطبخ لأطهو الغداء. قضيت قرابة ساعتين أقشّر الخضر وأغسلها وأنظف الأواني… حينما خرجت وجدته نائما. كان النوم يغالبه دائما في مثل هذا الوقت من التعب والإنهاك. لكنه لم يكن يشخر هذه المرة. ولم ينهض ليصلّي الظهر. اقتربتُ منه وحاولت إيقاظه ليتناول غداءه. لم يستيقظ. حرّكتُه بقوة، لكن بدون جدوى. كان قد نام نومته الأخيرة التي لن يوقظه منها أحد، ولا شيء، ولا مسؤولية، ولا عمل، ولا منبّه، ولا رنين هاتف، ولا آذان ظهر، ولا صفير طنجرة الضّغط. مات حميد. مات زوجي.